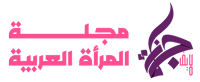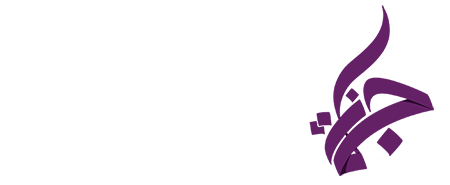إسكات الظربان الفرنسي وإبعاد اللعب إلى المنفى

تسنّ كندا قوانين تجريمية يُمنع بموجبها حتى المُزاح (Getty)
هل تهدد الصوابيّة السياسية حريّة التعبير؟ ما زال هذا السؤال قيد الجدل، ولا توجد إجابة مقنعة إلى الآن، خصوصاً في دول تبنت هذا الخطاب إلى الأقصى، كحالة كندا التي أُقرت فيها الوثيقة C-16، وعبرها يتم تجريم الألفاظ التي تعتبر مسيئة لأحد ما بسبب ميوله الجنسية. وهذا ما ينطبق على حالة ضمائر المخاطب، القضية التي أشعلت الرأي العام العالمي بعدما رفض جوردن بيترسون، الأستاذ الجامعي والمحلل النفسي، الانصياع لرغبات بعض طلابه بأن يخاطبهم بضمير “أنتم”.
الأمر ذاته تكرّر في فرنسا، مع مسرحية “كاناتا”، التي لم تعرض في كندا، وعرضت في فرنسا على خشبة مسرح الشمس، واتهم مخرجها روبيرت لوباج بالاستيلاء على التراث الأميركي الأصلي. والسبب أنه لا يوجد بين الممثلين أي ممثل من أصل أميركي، بالرغم من أن الموضوع يتناولهم، ويتناول العنف والعنصرية التي يتعرض لها. وكان الرد من قبل المسرحيين في فرنسا هو الدفاع عن حرية اللعب والتنكر، والتأكيد أن لعب الأدوار لا يمكن المساس به كونه جزءاً من حرية التعبير.
امتد الأمر إلى إعادة النظر في الماضي ومنتجاته، وإعادة قولبة هذ الماضي ليتلاءم مع “صوابية العصر”. وهذا ما يحصل حالياً؛ فمثلاً بعدما أعلنت شركة “وورنر بروذرز” نيتها إنتاج جزء ثان من فيلم الكرتون “سبيس جام”، الذي يدمج الشخصيات الكرتونية المحببة مع نجوم كرة السلّة، نفاجأ لاحقاً بأن الفيلم لن يضم الظربان الفرنسي “بي بي لو بو”، بسبب التهم التي لاحقته بوصفه يروج لثقافة التحرش الجنسي والاغتصاب، وفعلاً تم قصه من الفيلم وحذف المشاهد المقررة له.
الإشكالية الآن، وقبل الخوض في شأن حرية التعبير، هي أن الصوابية السياسية وصراع الهويات، جعلا اللعب واللاجديّة في خانة الجدّ المفرط. ولا نعني هنا أن صناعة الترفيه والثقافة بريئة وغير مسيسة، لكن وصل الأمر إلى حرمان الفنان من أداء أو تمثيل أو لعب شخصيات بحجة إما عدم تطابق مع التاريخ “الحقيقي”! أو بسبب الشر الذي تختزله هذه الشخصيات!
أما في ما يتعلق بحرية التعبير، فما زال الأمر إلى الآن غير مقنن، لكن ما أقرته كندا يهدد هذه الحرية، خصوصاً أنه يفترض معايير “صائبة” لتمثيل البشر والعالم، لكن هذا الصواب الذي يبتناه اليسار وأقصى اليسار أصبح إلى قوّة وخطاب يهدد الجميع، وسعي لخلق نموذج واحد، ينفي المختلف، بل ويحوله إلى عدو. نتحدث هنا عن المحافظين واليمين بأطيافه، كما أنه يهدد حرية اللعب بأبسط أشكاله، ولا نتحدث هنا عن الوجه الأسود مثلاً، بل عن الادعاءات أن شخصية ما، أو دوراً ما، يسيء إلى الصورة الأصلية لفئة ما، وكأن المشكلة والصراع يقتصران على “التمثيل”، ومدى مطابقته للجماعة التي يمثلها، ما ينفي بالأصل مفاهيم اللعب والفن القائمة على “سوء الاقتباس” و”التلاعب”، وكل هذه المفاهيم والكلمات الشعريّة.
ما زال الأمر إلى الآن في بداياته، خصوصاً أن القوانين لم تسنّ بعد، تلك التي تفرض علينا أسلوباً محدداً للكلام، باستثناء كندا. لكن هذا الأمر يهدد المزاح نفسه، فالكثير من الانتقادات توجه إلى العديد من الـ”ميمز” بسبب هذا الأمر، كالصورة الشهيرة لمارك والبيرغ على بوستر فيلم محمد علي كلاي، بوصفه سيلعب الدور عوضاً عن ويل سميث. الأمر ذاته في المسلسل الكرتوني الشهير ساوث بارك، حيث تظهر شخصية مدير المدرسة الجديد “المصيب سياسياً” بوصفه لا يهتم إلا بالنساء وبضرب أي أحد يقول كلمة خاطئة عن أي أقلية.
ما نحاول قوله إن هناك خطاباً يتمأسس ويقنن في بعض الأحيان، وتستخدمه فئة من الناس ترى أنها تتعرض لعنف بمجرد أن الآخرين، أفراداً ومؤسسات، يستخدمون ألفاظاً معينة وأساليب تعبير “إبداعيّة”، تهين هويتهم “الحقيقية”. هذا الخطاب يسعى إلى نمذجة نفسه ضمن أشكال محددة، تمارس عنفاً لا فقط على “اليمين”، بل على الأفراد في حياتهم اليوميّة، كما نرى في مسلسل ساوث بارك نفسه، حين يتعرض العديد من الشخصيات إلى التعنيف من قبل مدير المدرسة “المصيب سياسياً”، بسبب كلمات بسيطة يقولونها في جلسات خاصة، ويتم اتهامهم بممارسة عنف مايكروي ضد فئة هي ليست حتى موجودة في الغرفة ذاتها.